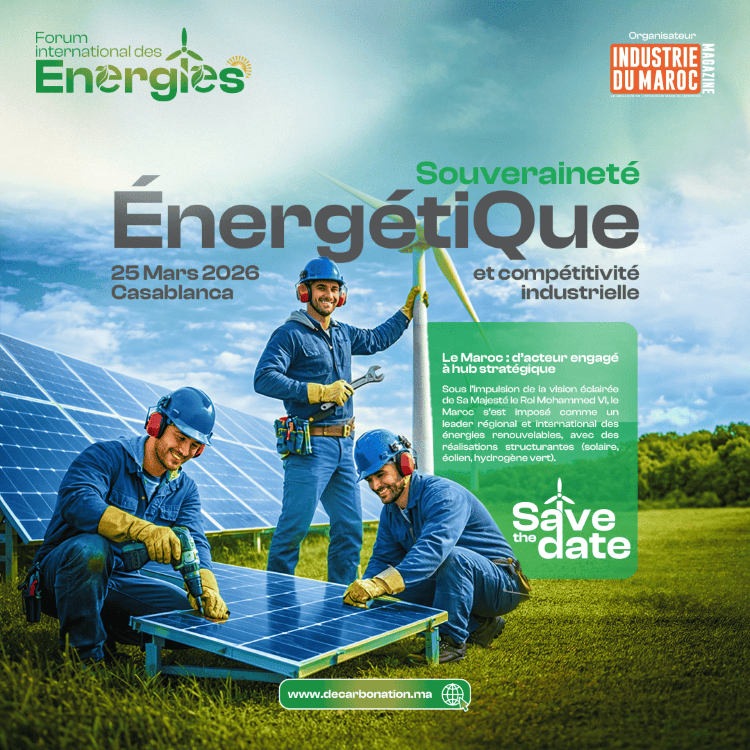للوهلة الأولى، بدت الفكرة أشبه باستفزاز سياسي. ففي عام 2019، حين لمح دونالد ترامب إلى رغبته في “شراء” غرينلاند، تأرجح الرأي العام العالمي بين السخرية والدهشة.
الدنمارك ردّت بحزم، ووصفت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الطرح بـ«العبثي»، مؤكدة أن غرينلاند ليست معروضة للبيع لأنها تعود قبل كل شيء إلى شعبها.
غير أن تلك الواقعة لم تكن مجرد نكتة دبلوماسية عابرة، فقد عكست منذ ذلك الحين شيئاً أعمق في طريقة ترامب في قراءة خريطة العالم. ومع حلول يناير 2026 عاد الملف إلى الواجهة بجدية أكبر، لأن التوتر لم يعد كلامياً فقط. فقد حذّرت وكالة “فيتش” من أن اندلاع أزمة حادة حول غرينلاند، في حال هزّت تماسك حلف شمال الأطلسي، قد يؤثر حتى في التصنيفات السيادية لدول أوروبا الشرقية. بعبارة أخرى، لم يعد الحديث عن نزوة سياسية، بل عن ملف بدأ يلامس التوازنات الاستراتيجية ويؤثر في تقدير المخاطر الجيوسياسية.
تحولت غرينلاند إلى هاجس لدى ترامب لأنها تختزل، في مساحة واحدة، أربعة رهانات كبرى للقرن الحادي والعشرين: العمق الدفاعي، وتنافس القوى الكبرى، ومعركة المعادن الاستراتيجية، ومسألة السيادة في عالم يزداد تصلباً.
جزيرة في موقع حاسم
ليست غرينلاند مجرد فضاء أبيض على هامش الخريطة. إنها نقطة تقاطع جيوسياسية. تقع في منتصف الطريق بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وتطل على القطب الشمالي، في منطقة لطالما نظر إليها الاستراتيجيون بوصفها مجالاً للعبور والمراقبة والتحكم.
وتزداد أهمية هذا الموقع مع التحولات التي يعرفها الشمال بفعل التغير المناخي وعودة منطق القوة بين الدول الكبرى.
هذا التحول أساسي. فبعد عقود ظل فيها القطب الشمالي مسرحاً بعيداً ومكلفاً، عاد اليوم ليصبح مجالاً للتنافس، مع تراجع الجليد، وفتح آفاق طرق جديدة، وارتباط أمن الشمال مباشرة بأمن المناطق الصناعية الكبرى.
طفي هذا السياق، تبدو غرينلاند قطعة محورية على رقعة الشطرنج الاستراتيجية، لا لأنها تحسم اللعبة وحدها، بل لأنها تتيح التموضع في المكان والزمان المناسبين قبل تسارع الصراع.
حضور أمريكي قائم بالفعل
الخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستبدأ من الصفر في غرينلاند. فواشنطن موجودة هناك منذ زمن. إذ تدير قاعدة عسكرية كبرى عُرفت طويلاً باسم “قاعدة ثول الجوية”، وأُعيدت تسميتها سنة 2023 إلى “قاعدة بيتوفيك الفضائية”.
وهذا التغيير في التسمية يعكس تطور دور الموقع، الذي بات جزءاً من منظومة المراقبة المتقدمة والدفاع الصاروخي، في عالم أصبحت فيه سرعة الإنذار والتحكم في زمن الاستجابة من عناصر التفوق الحاسم.
هنا يتضح جوهر الاهتمام الأمريكي. فغرينلاند ليست اقتناءً غريباً أو رمزياً، بل موقعاً متقدماً فريداً في الشمال، على أحد المحاور التي تتقاطع فيها التهديدات ومسارات الحركة وقدرات الرصد. ترامب لم يبتدع هذه العقيدة الأمنية، لكنه صاغها بأسلوبه المباشر، وحولها إلى لغة بسيطة أقرب إلى منطق “الامتلاك والإغلاق والمنع”.
القطب الشمالي يعود ساحة صراع
ليس من قبيل الصدفة أن يتصلب الملف مع احتدام التنافس الدولي. فالمنطقة القطبية أصبحت مجالاً تتقاطع فيه الطموحات الروسية والمصالح الصينية ورغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على تفوقها. وهذا ما يجعل القضية شديدة الحساسية أوروبياً. فعندما ترفض الدنمارك الفكرة، فهي لا تدافع عن مبدأ فحسب، بل عن منظومة قائمة على التحالفات والتنسيق، لا على منطق الضم والاستحواذ.
في يناير 2026 تحدثت ميته فريدريكسن عن “خلاف جوهري” مع واشنطن حول هذا الملف. وهو توصيف ثقيل الدلالة. فإذا بدا أن القوة الأولى في الحلف الأطلسي تنظر إلى إقليم مرتبط بدولة حليفة بوصفه “قابلاً للتفاوض”، فإن أساس الثقة داخل التحالف يتعرض للاهتزاز. وفي عالم تعاني فيه منظومة الأمن الجماعي ضغوطاً متزايدة، تصبح مثل هذه التوترات اختباراً حقيقياً لصلابة التحالفات.
معركة الموارد: البعد الاقتصادي
إلى جانب البعد الاستراتيجي، يبرز عامل الموارد، وخصوصاً المعادن الاستراتيجية. فغرينلاند تُعد منطقة واعدة في النقاشات المتعلقة بالعناصر النادرة والمعادن الحيوية. غير أن الواقع أكثر تعقيداً من الشعارات. فالمسألة ليست ما يوجد “تحت الجليد”، بل ما يمكن استخراجه عملياً وبأي شروط.
الدليل جاء من الداخل الغرينلاندي نفسه. ففي عام 2021 أقرّ البرلمان المحلي قانوناً يمنع استغلال اليورانيوم، ما أدى إلى تجميد مشاريع تعدين كبرى، بينها مشروع واسع مرتبط بالعناصر الأرضية النادرة. هذا يبرز حقيقة أساسية: غرينلاند ليست أرضاً صامتة أو مجرد مخزون موارد، بل كيان سياسي يتمتع بحكومة وخيارات وسياسات، وتعيش داخله نقاشات حادة بين متطلبات التنمية والمخاطر البيئية والمسار المؤسسي.
هنا يرى ترامب مدخلاً استراتيجياً. ففي عالم بات القلق فيه يتزايد بشأن سلاسل التوريد وهيمنة الصين على قطاعات حيوية، تتحول فكرة “تأمين المصادر” إلى هاجس. ومن هذا المنظور، تمثل غرينلاند وعداً بـ“السيادة الصناعية”، في زمن تعتمد فيه الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والتكنولوجيات المتقدمة على مواد لم تعد الدول تريد مجرد شرائها، بل التحكم فيها. غير أن هذا المنطق يصطدم بحقيقة بسيطة: غرينلاند ليست منجماً، بل إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي، ولا يمكن التعامل معه كرصيد قابل للتصرف.
سيادة تُمسّ وكرامة سياسية
من هنا تتحول القضية إلى مسألة شديدة الحساسية. ففكرة “الشراء” ليست فقط غير واقعية، بل تُعد سياسياً مهينة. غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي واسع. وهي ليست “شيئاً” ولا ورقة في لعبة دبلوماسية. والتحدث عن “اقتناء” الإقليم يعني، في نظر كثيرين، تجاهل الوجود السياسي لشعبه.
وقد برز هذا البعد بوضوح في يناير 2026، عندما أكد مسؤولون غرينلانديون علناً أن أي بيع غير وارد، وأن السيادة ليست موضوع تفاوض. وحتى عندما يبرر ترامب موقفه بدوافع “الأمن”، فإن النتيجة تبدو كضغط سياسي مباشر. ولهذا يتجاوز الملف حدود العلاقات الأمريكية ليطرح أسئلة حول منطق ما بعد الإمبراطورية، وصلابة التحالفات، ومكانة الشعوب في القرارات التي تمس مصيرها.
الهدف الحقيقي: التحكم لا التملك
في العمق، لا يسعى ترامب بقدر ما يسعى إلى توقيع عقد ملكية، بل إلى إحكام السيطرة على فضاء استراتيجي قبل الآخرين. يريد ضمان ألا تتحول غرينلاند إلى منطقة يتراجع فيها النفوذ الأمريكي، أو يتقدم فيها خصم، أو تُحسم فيها قرارات الموارد من دون واشنطن، أو يعاد تشكيل شمال الأطلسي على نحو أقل ملاءمة للمصالح الأمريكية.
لهذا فإن وصف الفكرة بـ“الجنون” قد يكون مضللاً. فما يبدو في الشكل مبالغاً فيه، يحمل في الجوهر منطقاً استراتيجياً واضحاً، لكنه يُطرح بأسلوب فجّ، بلا أعراف دبلوماسية ولا اعتبار للتوازنات القائمة. وهنا يكمن الخطر الحقيقي: في قسوة المنهج.
أزمة تتجاوز غرينلاند
أكثر ما يكشفه هذا الملف هو تداعياته الأوسع. فعندما تحذر “فيتش” من أن شرخاً داخل الناتو بسبب غرينلاند قد يؤثر في التصنيفات السيادية بدول أوروبا الشرقية، فهذا يعني أن القضية خرجت من خانة “الاستعراض السياسي” إلى دائرة المخاطر النظامية. كما يعني أن غرينلاند أصبحت رمزاً لعالم يتغير: عالم تعود فيه الجغرافيا لتكون سلاحاً، وتتحول فيه الموارد إلى أداة قوة، وتهتز فيه التحالفات تحت ضغط منطق القوة الأحادية.
لا يريد دونالد ترامب غرينلاند لأنه مولع بالأراضي الجليدية، بل لأنها تختزل جغرافيا السياسة العالمية المقبلة. فهي تمنح عمقاً استراتيجياً فريداً في الشمال، وتقع في قلب تنافس القوى الكبرى، وتعد بوابة لموارد حيوية للصناعات المستقبلية، وتختبر متانة التحالفات الغربية.
في عام 2019، بدت الفكرة مثاراً للسخرية. أما في 2026، فهي مدعاة للقلق. لأنها لا تروي قصة ترامب وحده، بل تحكي عن عالم يزداد تصلباً، تُقاس فيه القوة بالقدرة على إحكام السيطرة على الفضاءات قبل أن تصبح حاسمة. وفي هذا العالم، لم تعد غرينلاند هامشاً… بل أصبحت مركزاً.